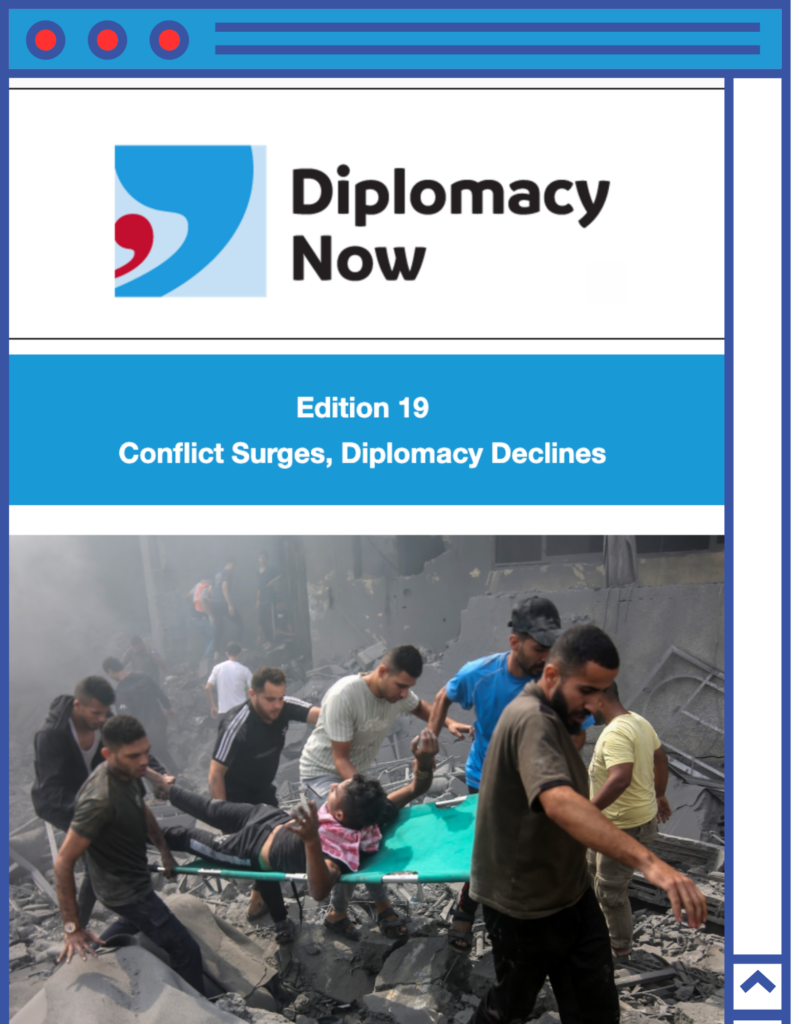لا يختلف المراقبون حول الطاقات الكامنة للاتحاد المغاربي، والتي بإمكانه – لو فَعَّلَهَا – الاضطلاعُ بأدوار جيو إستراتيجية غاية في الأهمية، نظرا لما يتميز به الفضاء المغاربي من موقع جغرافي مهم، وقوة بشرية هائلة، وثروات اقتصادية كبيرة، وتراث حضاري تاريخي ممتد عبر آلاف السنين.
وتتمتع دول الاتحاد المغاربي بعمق استراتيجي يقوم على أبعاد فريدة ومتنوعة: عربي -إفريقي – صحراوي – متوسطي – أطلسي، وبإمكان دول الاتحاد – إن توفرت الذهنية الإستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي، والإرادة السياسية للعب الدور – أن تخلق معادلات قوة إقليمية يحسب لها حسابها[1]، هذا فضلا عن الدراسات والتقارير التي تؤكد على المزايا والأرباح التنموية والاستراتيجية للتكامل المغاربي، والكلفة الباهظة لغياب هذا التكامل على جميع الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية والتنموية.
ومع هذا لا تزال وضعية مؤسسات الاتحاد المغاربي، بعد مرور 36 سنة على إنشائه، لا تعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين دول هذا الفضاء، ولا تعكس أبسط مظاهر الوعي بالتحديات المحيطة بدوله وشعوبه، ولا الرغبة في بناء مستقبل من التكامل والاندماج الاقتصادي والسياسي، يمثل فريضة حضارية وضرورة استراتيجية.
بل إن وضعية دول الاتحاد المغاربي تدهورت بشكل غير مسبوق، بالمقارنة مع ماضيه القريب، فالجزائر والمغرب في حالة قطيعة دبلوماسية وتدابر رسمي وشعبي غير مسبوق، وليبيا يمزقها الصراع الداخلي، وصارت ساحة للتدخلات والمبادرات الأوربية والإفريقية والتركية والمصرية والخليجية، في ظل غياب للمبادرات المغاربية الفعالة، بينما تمضي تونس نحو أزمة داخلية غير مسبوقة، وتراجع مؤسف لتجربتها الديمقراطية.
فأين يكمن الخلل؟ وما الجذورُ المؤسسةُ لهذا الوضع الشاذ؟
في نظري أن هناك أسبابا تاريخية وجغرافية ومؤسسية، تمثل الأرضية المُؤَسِّسة لهذه الحالة المَرَضية المزمنة، رغم التفاوت في حجم وتأثير تلك الأسباب، التي يأتي في طليعتها العامل المؤسسي بشكل مركزي.
تاريخيا ظلت بلاد المغرب الكبير، منذ الفتح الإسلامي، بلادا واحدة تحكمها الدول الإسلامية الكبرى، وأحيانا تحكمها دولة إقليمية واحدة، وفي أحايين أخرى تحكمها دول محلية متنافسة، ومع تمدد الخلافة العثمانية إلى بلاد المغرب الكبير أوقف سكان المغرب الأقصى تَمَدُّدَهَا على حدود تلمسان، وظل المغرب يُحْكَمُ من قِبَلِ دول محلية (السعديين ثم العلويين)، فأصبح هناك تمايز سياسي واضح بين الولايات العثمانية في بلاد المغرب الكبير والمملكة الشريفة في المغرب الأقصى، وتمايز نسبي بين ولايات مغاربية عثمانية تُحْكَمُ من خلال طبقات عسكرية تنحدر من مزيج “تركي – مغاربي”، مثل القرمانيين في ليبيا، والبايات في تونس، والكرغليين في الجزائر، في مقابل أسر شريفة تحكم المغرب نتيجة حركات وثورات من عمق تفاعلات السكان المحليين مع الأوضاع الداخلية والخارجية.
لقد نتج عن هذه الوضعية حالة تمايز وضعف في حركة التفاعل بين دول الفضاء المغاربي خلال هذه المرحلة التاريخية، رغم الوحدة المذهبية والعقدية ،التي حسم سكان المغرب الكبير أمرها بشكل نهائي منذ الثورة التي قادها العلماء المغاربة ضد الحكم الفاطمي الشيعي.
أما المحطة التاريخية الثانية، وربما الأكثر تأثيرا سلبيا في المسار المغاربي، فتتعلق بالمرحلة الاستعمارية الفرنسية، ففرنسا التي احتلت الجزائر سنة1830 ، حملت معها مشروعا إيديولوجيا واستيطانيا خطيرا، فقد اعتبرت فرنسا الجزائرَ مقاطعةً فرنسية في الشمال الإفريقي، فبدأت بتوسيع نطاق سيطرتها في كل الجهات، فاقتطعت مناطق عديدة من جيرانها،.وفي مقدمتهم المغرب الذي أُرْغِمَ على توقيع اتفاق 1901، الذي كان بمثابة إغلاق نهائي لقضية “إقليم توات والساورة “، ثم جاء برتوكول 1902 الذي أُرْغِمَ المخزنُ بمقتضاه على التخلي عن الأراضي الواقعة بين وادي “الزوزفانة وكير”،[2].
كانت مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار المرحلة الأكثر إشراقا في تاريخ الفضاء المغاربي، والأكثر تجسيدا لوحدته الوجدانية والثقافية والتاريخية، والأكثر تعبيرا عن ماضيه ومصيره المشترك، وكان لهذا التلاحم والتعاضد المغاربي دورٌ حاسم في طرد الاستعمار، ونيل البلدان المغاربية استقلالها الوطني، ويمكن القول إن فكرة الاتحاد المغاربي والأحلام والأدبيات المرتبطة بها نشأت في أحضان الحركة الوطنية المغاربية، في هذه المرحلة الذهبية من تاريخ المغرب الكبير المفعمة بالتحدي والطموح.
وعلى الرغم من اتفاق الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار كأساس للسلام والاستقرار في دول القارة إلا أن المغرب ظل يعتبر تلك الاتفاقيات غير منصفة، وبعد مرور عام واحد على استقلال الجزائر عادت من جديد مشكلة الحدود، وانزلق البَلَدَان في حرب الرمال عام 1963، التي تركت جِراحا غائرة في علاقات البلدين، وربما يمكن القول إنه لو تمت الإدارة الحسنة لمشكل الصحراء الشرقية ما كانت مشكلة الصحراء الغربية لتبرز وتفجر الوضع المغاربي على نحو ما فعلت ولا تزال تفعل إلى اليوم.
فقد كانت القمة الإفريقية في الرباط يونيو 1972 علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الدول الثلاث: المغرب والجزائر وموريتانيا، وبحسب الرئيس الموريتاني الأسبق المختار داداه فإنه لو قام الملك الحسن الثاني بالتصديق على اتفاقيات الرباط 1972 بشأن الحدود الجزائرية المغربية لَمَا استمالت الجزائر جبهة تحرير الصحراء المولودة في ازويرات بموريتانيا لتكون نواة للبوليساريو، وبعبارة أخرى فإن حرب الصحراء ما كان لها أن تكون لو أن ملك المغرب صدق على اتفاقيات الرباط[3].
والحقيقة التي لا مراء فيها، والتي تشهد لها قرائن عديدة، أن مشكلة تعثر مسار الاتحاد المغاربي، وعجزه المخيب للآمال عن تحقيق نتائج ذات بال على درب التكامل والاندماج، وتفعيل الشراكات بين دوله، لا تعود لمواريث التاريخ أو مشكلات الجغرافيا الموروثة عن الاستعمار، بل هي – بالأساس – أزمة مؤسسات مرتبطة بتأثيرات التسلطية في مقابل العجز الديمقراطي، فمسارات التحول الديمقراطي في الدول المغاربية الخمس لا تزال تراوح قدميها في المنطقة الرمادية، حيث تسود ديمقراطية هجينة، لم تعد تسلطية صرفة ولا هي تسير بوضوح نحو الترسيخ الديمقراطي، فرغم المظاهر والأشكال الديمقراطية لا تزال “قوى فوق الدولة” تملك اليد الطولى في رسم السياسات والتوجهات العامة لهذه الدول، وليس المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.
وفي نظري فإن تحقيق التكامل المغاربي مرتبط بشكل وثيق بمستقبل مسارات التحول الديمقراطي في البلدان المغاربية، فالتقدم االديمقراطي في هذه البلدان يمثل رهانا حقيقيا ووحيدا على مستوى النهوض والتكامل المغاربي، وذلك للاعتبارات التالية:
أولا – ما تتيحه الديمقراطية من إطلاق الحريات الفردية، والمبادرات الذاتية، وسيادة القانون، وهي أمور تساهم في خلق النموذج الاقتصادي الذي يقود إلى الازدهار ويقضي على الفقر، وبالتالي خلق طبقة وسطى واسعة قادرة على حماية المؤسسات المنتخبة، وتقليم أظافر “قوى فوق الدولة”، الراعي الرسمي للتسلطية. والديمقراطية الراسخة هي التي ستحقق الاستيعاب والدمج لكافة ألوان الطيف السياسي والمجتمعي والديني داخل المؤسسات الشاملة للجميع[4]، ولا يخفى ما للديمقراطية من مزايا بخصوص إضفاء الشرعية على القادة السياسيين، وتشجيع التأييد الشعبي للدولة، وضمان تصرف الممثلين السياسيين وفقا لوجهات نظر المواطنين محليا.
ثانيا – على الرغم من أن الديمقراطيات تخوض أحيانا حروبا مختلفة، لكن هناك استنتاج تم تأكيده في أبحاث مختلفة يؤكد حقيقة مفادها أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض، وهناك اتجاه عالمي يتطلع إلى عالم أكثر سلاما، تتسم فيه العلاقات الدولية بالتعاون بدلا من الصراع. وفي كتابه “السلام الدائم” يقدم الفيلسوف الألماني كانط فكرة الاتحاد السلمي النابع من الانسجام بين الديمقراطيات، ويقدم كانط ثلاثة عناصر تكرس ارتباط الديمقراطية بالسلام:
– المعايير الديمقراطية لحل النزاعات سلميا )الديمقراطية تكرس ثقافة الحلول السلمية للنزاعات(؛
– العلاقات السلمية بين الدول الديمقراطية تقوم على قواعد أخلاقية مشتركة )الديمقراطيات تتمسك بقيم أخلاقية مشتركة، وبأن الأواصر التي تبنيها فيما بينها بسبب هذه القيم تؤدي إلى تشكيل اتحاد سلمي(؛
– التعاون الاقتصادي بين الديمقراطيات وروابط الاعتماد المتبادل )حيث أن الاتحاد السلمي يجري تعزيزه بواسطة التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل[5](.
ثالثا – تسهم الديمقراطيات في استئصال بعض الدوافع المهمة للسياسات التوسعية، حيث تنبع الروح العدوانية للحكام تجاه الخارج من رغبة الحكام غير الديمقراطيين في تعزيز مواقفهم في الداخل، كما أنها قد تنتج عن سعي الحكام وراء الاعتراف بهم، لا من رعيتهم فحسب، وإنما من الدول الأخرى أيضا[6].
رابعا – الديمقراطية ستبرز التعبير الحقيقي عن طموحات الشعوب المغاربية، وتمكن للاتجاهات السياسية الوحدوية صاحبة المصلحة في التكامل الطوعي، بل أراهن أنها يمكن أن تشكل الأرضية الملائمة لحل النزاع المزمن في “الصحراء الغربية”، على قاعدة حل يوفر للصحراويين التميز الاجتماعي والثقافي والسياسي، ويضمن للمغرب وحدته، أو قيام كونفدرالية ،ليس فقط بين المغرب و”الصحراء الغربية”،بل يمكن أن تكون بين جميع الدول المغاربية ، أو حتى نمط اتحاد شخصي “كومنولث”،على غرار علاقة استراليا وكندا مع التاج البريطاني رغم احتفاظ هذه الدول باستقلالها وإرادتها الحرة ونموذجها الخاص ،إلى غير ذلك من الصيغ التي يمكن ابتداعها في مناخ ديمقراطي حر .
لقد نهض الاتحاد الأوربي عل ركام من الحروب المدمرة والصراعات المريرة ،لكن تجذر الديمقراطية وحكم المؤسسات وتراكم الوعي وإخلاص الزعماء قادهم في النهاية إلى التكامل والاتحاد ،فهل تبادر “فرنسا -ألمانيا” المغرب العربي “المغرب -الجزئر” إلى استخلاص الدروس وتجاوز عقد الماضي.
الدكتور سيدأعمر شيخنا باحث موريتاني متخصص في التاريخ والعلوم السياسية
مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات في موريتانيا ومدير دار قوافل للنشر .
له عدة كتب ودراسات في قضايا التاريخ الموريتاني وقضايا التحول الديمقراطي وأزمات الساحل الصحراوي.
[1] -أنظر أحمد داود أوغلو:العمق الاستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبدالجليل ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت –الدوحة ،ط1 ، 2010،ص 33ومابعدها
[2] -محمد بوكبوط، صفحات مجهولة من مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،الرباط،ط1 2005،ص 42
[3] الرئيس المختار ولد داداه: موريتانيا على درب التحديات، دار كارتيلا ،باريس،ط1 ،سنة 2004،ص465 .
[4] -أنظر : دارن اسيموجلو –جيمس أ. روبنسون،لماذا تفشل الأمم،أصول السلطة والإزدهار والفقر،ترجمة بدران محمد ،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية،ط1،القاهرة،2015
[5] – غيورغ سورنسن، الديمقراطية والتحول الدمقراطي.. السيرورات والمأمول في عالم متغير، ترجمة: عفاف البطاينة، الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى بيروت، أبريل2015،ص201
[6]– غيورغ سورنسن، الديمقراطية والتحول الدمقراطي.. السيرورات والمأمول في عالم متغير،ص 208